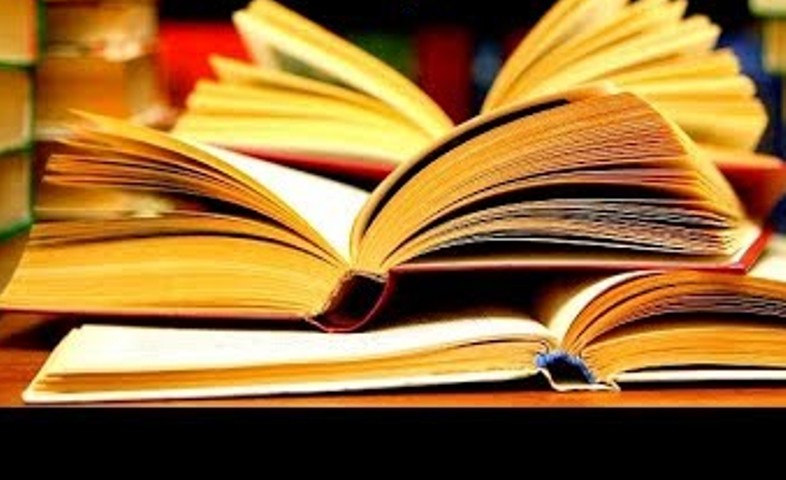علم الاجتماع الحديث/ قراءة موجزة في الجذور التاريخية
بقلم جلال النجفي
منذ آلاف السنين عرفت البشرية ظهورا للتجمعات الإنسانية التي كان وجودها ضرورة من ضرورات مجابهة الأخطار التي تهدد الإنسان الفرد، وحاجة من حاجات المقاومة للأخطار الطبيعية وغير الطبيعية التي لا يمكن مقاومتها من دون تلاحم عضوي تشترك فيه الأسرة الواحدة أو مجموعة الأسر (القبيلة) أو مجموعة القبائل (الشعوب) من أجل الاستمرار في الحياة على وجه هذه البسيطة.
وبهذا فإن التفكير بالآليات التي تحكم بناء المجتمعات وطرق تكونها هو تفكير موغل في القدم، ولكن تحول هذا التفكير إلى علم خالص، وإلى تخصص يأخذ حصته في الجامعات والمعاهد المهتمة بالعلوم الإنسانية يرجع إلى العصر الحديث، أي إلى ما يزيد قليلا عن القرن عندما ظهرت قبل أكثر من قرن تقريبا إرادة تأسيس علم مستقل بذاته يدرس الظواهر الاجتماعية، ويعد (إميل دوركايهم) أول عالم اجتماع يبلور منهجا علميا لعلم الاجتماع من خلال كتابه المشهور "قواعد المنهج في علم الاجتماع" الذي ظهر في العام 1895م.
وبكل حال من الاحوال لا يمكن فصل علم الاجتماع عن تاريخ الفكر البشري بانطلاقاته الانسانية الاولى التي ترجع إلى كتابات المنظرين والمفكرين والمصلحين الاجتماعيين والمهتمين بعلوم الانسان في المجتمعات الصينية والمصرية والرافيدينية والهندية واليونانية القديمة، وقد غلبت على هذه الأفكار مجموعة من السمات والخصائص التي تشير إلى غلبة التحليل الغيبي الاسطوري للظواهر الاجتماعية التي كان يجري مناقشتها ومداولتها بوعي قبلي محكوم بالطابع المحلي العشائري في تفسير الاحداث والوقائع الاجتماعية المهمة والكبيرة.
ومع ظهور المجتمع اليوناني القديم المعروف بميوله الى التفلسف والسفسطة بدأت ملامح الوعي بالتشكيل المجتمعي المتكون من سادة وعبيد تتضح من خلال من خلال تقسيم العمل الاجتماعي إلى قسمين (عمل فكري مترف) من شأنه أن يختص به طبقة النبلاء والسادة، وعمل يدوي خشن يمارسه العبيد والطبقة الدونية بالمجتمع وكما دون لنا ذلك المتابعون والمحللون اليونان من فلاسفة وغيرهم، وشاهده كتاب جمهورية افلاطون المنسوب إلى الفيلسوف اليوناني افلاطون (347 ق.م) الذي حاول قدر الامكان أن يخلص الافكار الاجتماعية من أسطوريتها وأن يقترب بها من مجال العلم، وإن لم يكن العلم القائم على البرهان والدليل العلمي القاطع. لكن ما تركه هذا الفيلسوف يمثل طليعة الوعي البشري بتشكل المجتمعات التي فسر ظهورها على أنه ضرورة طبيعية تسعى الى اشباع الحاجات المختلفة بطرق واساليب مختلفة.
وقد سار (أرسطو 322 ق .م) تلميذ افلاطون على خطى استاذه مع الاخذ بنظر الاعتبار انه استند الى أرضية واقعية تعتمد على ما يمتلكه الانسان من قابليات الحواس في إدراك المحيط وتفسيره، ولذلك يعد أرسطو الإنسان كائنا مدنيا بطبعه، وإن هذا الكائن محكوم إلى بنية اجتماعية صغرى هي الأسرة وأخرى كبرى هي المجتمع، وإن دور البنية الاولى الصغرى يتمثل من خلال السعي إلى إدماج الانسان بالبنية الكبرى (المجتمع) لكي يمارس دوره المنوط به في التفاعل والانتاج المثمر.
في حين كان الرومان الذين تأثروا بأفكار اليونان بسبب القرب الجغرافي والغزوات والحروب المستمرة بين الطرفين قد حاولوا إعادة إنتاج أفكار الإغريق مع ميزة أنهم حاولوا تنظيم العلاقة القائمة بين الدولة وبين المجتمع، مع محاولتهم الخجولة لسنّ قوانين اجتماعية تصلح للتطبيق في كل المجتمعات الانسانية القائمة آنذاك، ومع محاولة للإصلاح الاجتماعي بما يخص التفاوت الطبقي الذي فسرته الكنيسة الرومانية على أنه أمر قدري خلاصه في الحياة الأخروية القادمة بعد موت الإنسان.
وفي المحيط الإسلامي سعى المفكرون المسلمون في تفسيرهم للظاهرة الاجتماعية من خلال محاولاتهم الدائبة على التوفيق بين الدين والفلسفة، بهدف تفسير الشرائع التي جاءت لصناعة الأنسان وتهيئته تهيئة صالحة ليمارس دوره المنوط به وإعداده ليكون خليفة في هذه الارض وليعمل صالحا دون عدوان وفساد. إذ حاول الفرابي المتوفى سنة 339هجري أن يتخيل مدينته الفاضلة التي هي عبارة المجتمع الذي تتحقق فيه السعادة للأفراد على أكمل وجه ، على غرار جمهورية أفلاطون تسودها مبادئ العدالة والحق ويعيش فيها الأفراد على نحو من التكامل والوفاق ،علماً بأن السعادة التي ينالها الأفراد في المدينة الفاضلة لا يمكن أن تتحقق وتتضح للعيان إلا إذا تعاون الأفراد بينهم بنوع من التكافل الاجتماعي ، وإلا إذا اختص كل واحد منهم بالعمل الذي يحسنه وبالوظيفة المهيأ لها وفق طبيعته البشرية والبيولوجية الخاصة به دون سواه .وهكذا يبدو لنا أن المجتمع وبنائه يتمحور حوله فكر هذا الفيلسوف المسلم الذي استلهم انموذج إفلاطون وحاول أن يطوره على وفق الواقع الاسلامي الهادف إلى بناء مجتمع سعيد يمارس فيه الجميع أدوارهم على قدم وساق.