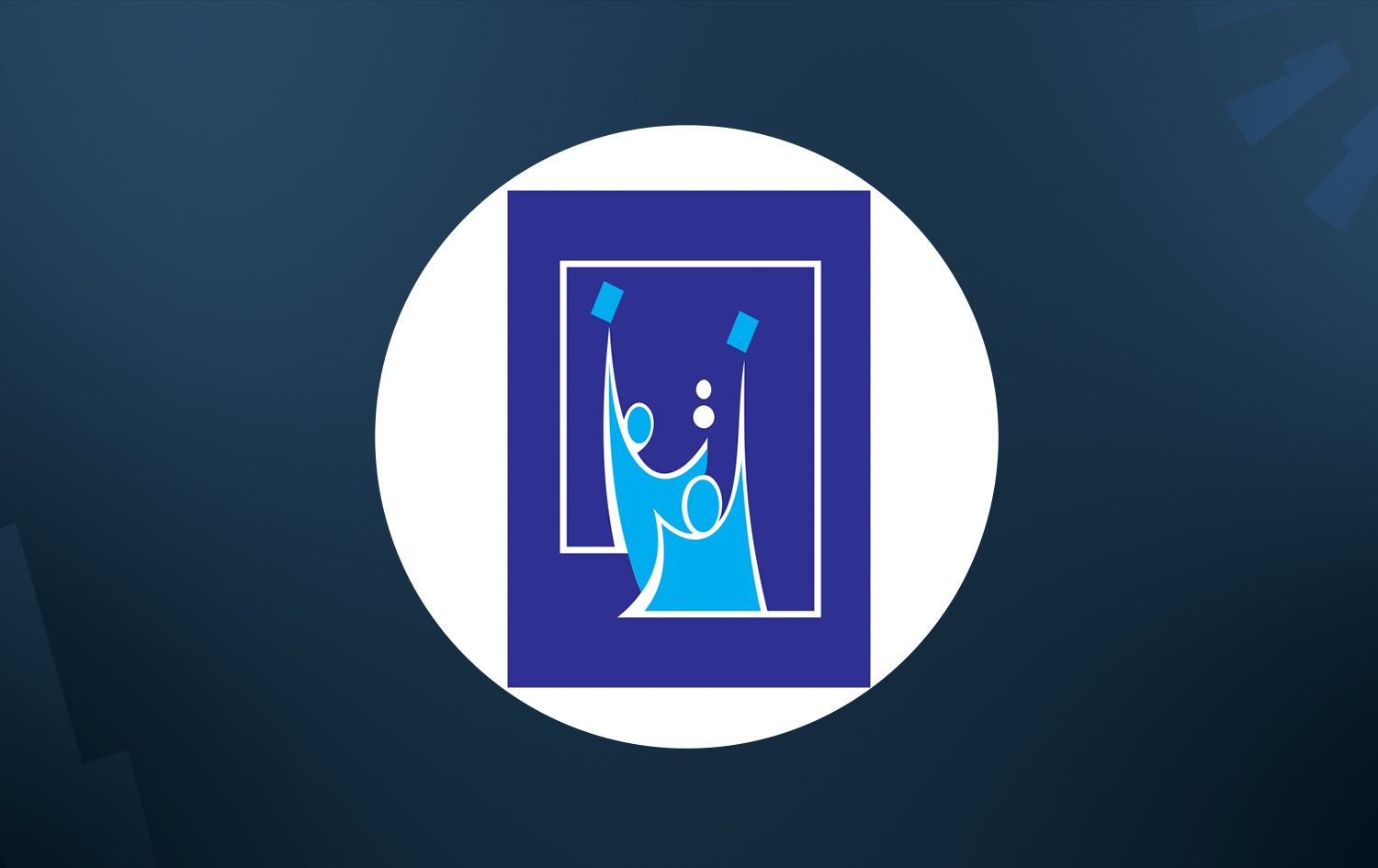في ذكرى ولادته العطرة.. محطات منيرة من سيرة الرسول الأعظم (ج1)
لشخصية الرسول الأكرم حضور طاغ في قلوب المسلمين وفي وجدانهم جميعا ، لا بل أن حضوره تعدى تأثيره الدائرة الإسلامية وصولا إلى الدائرة الإنسانية والعالمية كلها، فقد عدّه الكاتب الأمريكي المعاصر( مايكل هارت) أعظم رجل في العالم من حيث قوة تأثيره ضمن الكتاب الذي أطلق عليه عنوان ( الخالدون مائة، أعظمهم محمّد رسول الله) وقد نقله إلى العربية المترجم المصري أنيس منصور، وكانت هذه المنزلة ضمن أهم مئة شخصية إنسانية منذ فجر التاريخ وحتى يومنا هذا، لما للرسول من قوة الشخصية وقوة التأثير في الوجود البشري على هذه الأرض.
وعند تقليب صفحات سيرة الرسول الأكرم العطرة يتبين لنا بعضا من عظمة هذه الشخصية التي نقلت العالم من الظلام الى النور، ومن الضلالة إلى الهدى، بعد أن كانت عبارة عن قبائل تتنهاش بينها، يأكل القوي منها الضعيف، فالمرأة تقتل لأنها قد تكون عارا للقبيلة إذا ما غزيت من قبيلة أخرى، والمجتمع كله يئن تحت قوانين ظالمة ما أنزل الله بها من سلطان.
إذ تشير كتب السيرة إلى أن محمّداً هو: أبو القاسم بن عبد الله، بن عبد المطلب شيبة الحمد، بن هاشم بن عبد مناف بن كلاب بن مُرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النظر بن كنانة بن خزيمة بن مُدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أٌدّ من نسل إسماعيل ابن النبي إبراهيم (عليهما السلام). ويؤكد هذا النسب الذي أثبته الأوائل لمحمّد كل المؤرخين اللاحقين، فقد ولدته أمه (آمنة بنت وهب) في (12 ربيع الأول من العام الثالث والخمسين قبل الهجرة الموافق للعام 571م )، لأب مات قبل ولادته هو: عبد الله بن عبد المطلب، ليواجه الأهوال القادمة بجنان متماسك وبنفس كبيرة اعتادت على الصبر والجلد والتحدي وشظف العيش، وقد عمق هذه القوة النفسية والاعتماد على الذات -تاليا- موت أمه آمنة، وهو لما يزل في الخامسة من عمره ليتكفل برعايته جدّه عبد المطلب الذي ما لبث أن التحق بالرفيق الأعلى، ومحمّد الغلام في أحوج ما يكون إلى مثل هذا الجد الحاني الأمر الذي دعا عمه أبو طالب لرعايته، وقد ظل حاميا له ومدافعا -فيما بعد - عن نبوته بكل إيمان وصدق بعد أن تصدع الأهل والأقربون عنه، وبعد أن كفره قومه ونبذته قريش إلا المؤمنين منها بصدق دعوته وهم أقل من القليل.
وقد عزّز مكانته في مكة أن أهلها لقبّوه بـ(الصادق الأمين) الذي لم يكن كشباب مكة –آنذاك- شارباً للخمر مقبلاً على اللهو. وبينما كان هذا الشاب الشريف في قومه والغريب معا يسير في أزقة مكة وأسواقها، فيسمع الكذب الذي تنثره أفواه الباعة والتجار؛ فإنه يرتعد من قسوة الناس، ومن هوان الصدق والحق، فيقاوم كلّ ذلك الزيف بما يستطيع من قوة، ومن تعبير حي يجود به لسان فصيح، وتتلألأ به عين يشع منها سؤال كبير مفاده: ما قيمة الدنيا بلا صدق؟ وما أهمية الوجود بلا أمانة؟ وما فائدة البقاء بلا نبل وتضحية من أجل الحق والخير والإنسانية؟.
وحينما انتقل جده عبد المطلب إلى بارئه تولى رعايته عمه أبو طالب الذي كان فقيرا بسبب كثرة عياله، فطال الفقر والعوز محمداً كما طال أبناء عمّه، ولكن ذلك لم يصدع من عزيمته ولم يحن له رأسا، ومما عرف عنه هو أنه كان ينكسر لما يرى عليه الناس من غرقهم في الزيف الذي يلون حياتهم كلها سواء في عباداتهم الزائفة أو تعاملهم في الأسواق القائم على الربا والتضليل من أجل الكسب غير المشروع؛ فتأخذه -بسبب آلامه وأوجاعه من كل هذا الزيف والبطلان- شعاب مكة ودروبها إلى جبل قصي يجد في الاختلاء والتأمل بين جدران غار منعزل من شعابه راحة لا مثيل لها، واحساسا إنسانيا بالصفاء مع هذه الطبيعة الهادئة التي تبعث على التفكير في الوجود والمصير.
ولما كانت مدينته مكة التي ولد فيها وترعرع حتى صار شابا تقع في نقطة اتصال التجار بين الجنوب حيث اليمن وخيراتها والشمال حيث بلاد العراق والشام وما فيهما مما تحتاج إليه الأسر من قمح وحبوب وبضائع وسلع، كان لا بد لمحمّد (الصادق الأمين) على الرغم من فقره، وضيق ذات يده أن يكون موضع اعتزاز التجار ومستهلكي البضائع على حدّ سواء، وهو ما دعاه إلى أن يجرب حظا في التجارة التي احتكرتها بيوت من قريش، وكان من بين هذه البيوت بيت (خديجة بن خويلد) وأهلها الذين كان متجرهم إلى الشام واليمن في كل عام مما جعلهم من أصحاب المال والجاه والرفعة في المنزلة.
وقد اشتغل محمّد في التجارة بعد أن انتدبته ابنة عمه(خديجة) الشريفة في قومها، والعزيزة بين أهلها وكيلاً لتجارتها عبر القوافل الدورية بين الشام واليمن ، بسبب ما رأته من خصاله الحميدة، وما لمسته من عفته وحسن أخلاقه وأمانته وصدقه، وهو ما رغبها -من ثم لاحقا- في الاقتران به ليكون زوجا لها على عرف المجتمع المكي بعد عودته من رحلة طويلة إلى الشام، إذ تقدمت إليه بحسب أعراف القوم وقوانينهم القبلية آنذاك قائلة: ( يا ابن عم، إني رغبت فيك لقرابتك، وسطتك في قومك، وأمانتك وخلقك، وصدق حديثك...)
فقبل عرض خديجة وأصدقها عشرين بكرة عربونا لعلاقة حميمة لا يوهن عراها إلا الموت، ليبدأ بذلك صفحة حياة جديدة من حياته الكفاحية، وهي صفحة الزوجية والأبوة ومسؤوليتها، لا سيما بعد أن رزقهما الله بالولد والبنات الذين يحزن لحزنهم وشقائهم ويسعد لسعادتهم، وكان أهل مكة يحسدونه على ما هو فيه بعد أن منّ الله عليه بالمال حينما كان يتيما فآواه، ثم عائلا فأغناه الله من رزق طيب حلال ليعرف قيمة الأشياء بعد نوالها بالجد والاجتهاد.
لكن محمّداً من دون الناس كان مع كل هذا مهموما مكروبا دائم الحزن، فهو لا يشعر بانجذاب إلى الآلهة التي يتقرب إليها قريش قومه فيسجدون لها، ويذبحون وينذرون، ويسكرون تحت نصبها جهارا، ولا يأنفون من غزو ومن سلب ومن قتل للإناث الضعيفات، وكان هذا الواقع المأساوي المظلم يدفع به كلما سنحت الفرصة إلى ذلك الغار القصي في الجبل البعيد، حيث التجرّد من كل شيء وحيث الفراغ الذي يجعل الروح تنصت إلى كل نأمة تهمس بها هذه الجبال التي ( كأنها تريد أن تفصح له عن ماهيّته ) كما يعبر أحد كتاب السيرة النبوية المطهرة من المعاصرين.
وحين شارف محمّد على الأربعين عاماً وهو المكتمل جسداً وعقلًا امتلأت نفسه إيمانًا لكثرة الرؤى الصادقة التي كانت تتردد عليه فتجعله يتطلع إلى حقيقة هذا الوجود، وما يقف خلفه من عوالم بحاجة للكشف والتمعن وإطالة النظر والتأمل.
ويصل محمّد ذات يوم إلى زوجه وابنة عمه الحانية المحبة مرتجفًا قائلًا لها: (زملوني، زملوني)، ... إنه البرد الذي يعقب التحول العظيم من الرجل الذي يأكل الطعام ويمشي بالأسواق إلى الرجل الذي ينزل عليه خبر السماء في الصباح والمساء، وصار المستضعفون والفقراء والمظلومون والمضطهدون من أنصاره ومريديه، بينما عاداه سادة القوم وأصحاب الأموال، وكل من رأى في هذا الذي يدعو إليه محمّد تهديداً لوجوده ومصالحه ومركزه الاجتماعي. ولما كانت النبوة ماهية مقدسة تتعالى على العادي والبشري، فالنبيّ هو –إذن- حامل الوحي، وهو الوسيط الذي يلتقي عنده المقدس بالعادي، ويقول ابن سينا في هذا الخصوص: (وأفضل الناس من استكملت نفسه عقلاً بالفعل، ومحصلاً للأخلاق التي تكون فضائل علمية، وأفضل هؤلاء، هو المستعد لرتبة النبوة، وهو الذي في قواه النفسية خصائص ثلاث هي: أن يسمع كلام الله، ويرى ملائكته، وقد تحولت له على صورة من الصور فيراها بعين الحقيقة.
أما منطلق الرسول الأكرم محمّد بعد بعثته فقد كان منطلقًا أخلاقيًا يهتم بمظاهر السلوك الاجتماعي كالحثّ على المساواة وإطعام اليتيم ورعايته، وإنصاف المظلومين والمحرومين بغض النظر عن جنسهم ولونهم وانتمائهم، ثم تصاعد هذا المنطلق وتسامى ليتحول إلى ما يهدد قريش ومركزيّتها من خلال الدعوة إلى التوحيد وهجر عبادة الأصنام التي أصبحت على رأس مكارم الأخلاق حيث جاء محمّد ليتممها على أحسن وجه، مثلما كانت سبباً مباشراً لكل هذا البغض والكراهية التي قابلته بها قريش لثنيه عن مراميه وأهدافه.
وكان من أهم ثمار هذه الدعوة هو إقرار الصلاة التي أقامها محمد وأصحابه علنا متحديا أرباب قريش ، ولذلك حاولوا بعد أن استشعروا الخطر أن يبيدوا كل هؤلاء وبكل الوسائل المتاحة لئلا يسلبون منهم سلطتهم الموهومة، فمحمد قادر على التأثير بالآخرين بشكل عجيب حتى كانت قريش تظن أنه ساحر يغير القلوب والعقول بفصاحته وحجته وسرعة بديهيته.
للمحطات بقية